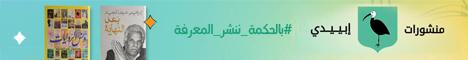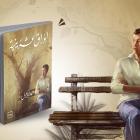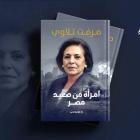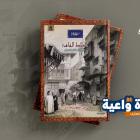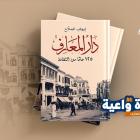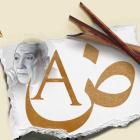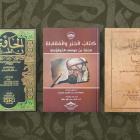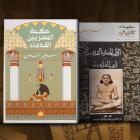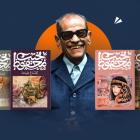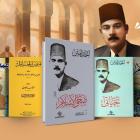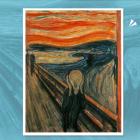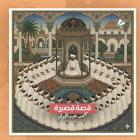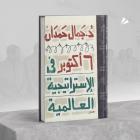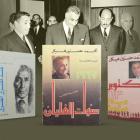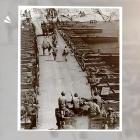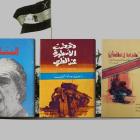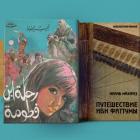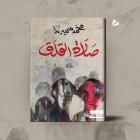معرفة
إعادة التفكير في الجيوبوليتيكا
من قلب محاضرةٍ عمرها 120 عامًا، إلى صعود الصين وتراجع أمريكا... صراعات الجغرافيا السياسية تعيد رسم خريطة العالم من جديد.
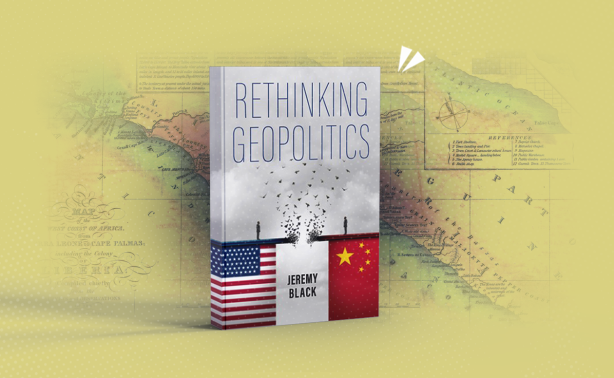 غلاف كتاب «Rethinking Geopolitics» للمؤلف جيريمي بلاك
غلاف كتاب «Rethinking Geopolitics» للمؤلف جيريمي بلاك
قبل أشهر قليلة، أصدرت جامعة أنديانا كتابًا مهمًّا من تأليف جيريمي بلاك. وقد انطلق الكتاب مدفوعًا بحلول الذكرى الـ120 للمحاضرة الشهيرة التي ألقاها المفكر الجغرافي الكبير هالفورد ماكيندر عن «المحور العالمي لقلب الأرض الأوراسي».
لقد كانت النقطة الأساسية في محاضرة ماكيندر هي ملاحظته الكاشفة آنذاك عن انتقال مركز القوة العالمي من دور القوات البحرية إلى دور القوات البرية، أي الانتقال من «قوى البحر» إلى «قوى البر».
وكانت وسيلة التغير الأساسية آنئذٍ هي السكك الحديدية العابرة للأقاليم والقارات، والتي أصبح بوسعها نقل القوات والمعدات والجنود والعتاد والمؤن.
ذهب ماكيندر إلى أن خط السكة الحديدية العابر لسيبيريا مكّن موسكو من تحريك القوات بسرعة حول «قلب» أوراسيا و«محورها»، بحيث أصبحت روسيا قادرة على تهديد خصومها، سواء اليابان في الشرق الأقصى، أو المصالح البريطانية في الهند، أو منافسيها الأوروبيين. قدّم ماكيندر «قلب أوراسيا» على أنه «المنطقة المحورية لسياسة العالم، في الماضي والحاضر والمستقبل»، وزعم أن السيطرة عليها ستهدد القوى الأخرى.
واقترح ماكيندر أن التحالف بين القوى البحرية يمكن أن يكبح جماح قوى أوراسيا القارية، وهو نهج ربط بين بريطانيا العظمى الإمبراطورية والولايات المتحدة.
لم ينكر ماكيندر دور القوى البحرية، لكنه أوضح فكرته قائلًا:
«لا يمكن إنكار أن النقل البخاري وقناة السويس قد زادا من مرونة القوة البحرية مقارنةً بالقوة البرية، لكن السكك الحديدية العابرة للقارات تُغيّر الآن قواعد الصراع مع القوى البحرية وتزيد من قدرات قوى البر».
خلال محاضرته، نوّه أحد الحضور حول العصر الجوي وإمكانات التحوّل المستقبلي. لكن بمعايير عام 1904، كانت محاضرة ماكيندر إضافة وتنويرًا فكريًّا جديدًا لصنّاع الخرائط والحروب، حول انتقال محور الصراع من البحر إلى البر، ومن ثم التركيز على الدول ذات القدرات البرية الكبيرة: لا سيما ألمانيا وروسيا. بل إن الولايات المتحدة ظهرت أيضًا كقوة مهدِّدة للتفرّد البريطاني بزعامة العالم، واعتُبرت أن الدول الثلاث (روسيا، وألمانيا، والولايات المتحدة) تمثل اقتصادات نامية ودولًا توسعية.
هل يكرر التاريخ دورته أم تتبدل الجغرافيات السياسية؟
يذهب الكتاب الذي بين أيدينا إلى أنه بعد 120 سنة من ظهور الولايات المتحدة كقوة نازعت المملكة المتحدة، وحلّت محلّها لاحقًا، فإننا اليوم شهود عيان على ظهور الصين كقوة عظمى يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة، في هذه الدورة الجديدة من الجيوبوليتيك (الصراع الجيوسياسي للسيطرة على العالم).
ليس المتوقع ظهور نموذج عسكري صيني يواجه النموذج الأمريكي الغربي فحسب، بل إن الأمر يشمل أيضًا النموذج الحضاري؛ فالعالم يشهد اليوم تحديًا جديدًا تسعى فيه الصين عمدًا إلى معارضة النماذج الدولية الأمريكية. فالصين تعتبر الليبرالية العالمية الأمريكية بمثابة أكبر تحدٍّ للسيادة الوطنية، علاوة على ما تتسم به من أنانية واضحة. في المقابل، تُقدّم الصين نموذجًا شيوعيًّا بديلًا، يمكن تسميته بـ«الاشتراكية المُدارة» managed socialism، أي الاشتراكية التي استلهمت أفضل ما في نموذج اقتصاد السوق.
وتنطلق الصين في طموحها هذا من حقيقتين واضحتين:
-
معاناة الولايات المتحدة من انقسام حاد حول مسألة التفاعل مع العالم الخارجي.
-
إعادة قادة الولايات المتحدة الجدد ترتيب الأولويات في المجالات والمهام الاستراتيجية، مثل الالتزامات المتضاربة تجاه تايوان وأوكرانيا والشرق الأوسط.
يُطلعنا الكتاب على أطروحة «انتقال الإمبراطوريات»، حيث تصعد دولة إمبريالية لتحتلّ مهمّة ومكانة دولة إمبريالية سابقة. وكان هذا محفّزًا لبريطانيا، التي اعتبرت نفسها وريثة روما، بل وحملت لقب «روما الجديدة»، بينما نظرت روسيا إلى بيزنطة كمثال وقدوة، ونظرت ألمانيا واليابان إلى فترات سابقة من القوة الإمبريالية. كانت النماذج الحضارية حاسمة لهذه الفكرة الجيوسياسية، حيث استند ادّعاء السيطرة إلى شعور بالقدر والمصير. ومن ثمّ، يذهب الكتاب الذي بين أيدينا إلى رصد أوجه التشابه بين القضايا الجيوسياسية التي واجهتها بريطانيا في الماضي، وما نظيرتها من المسائل الجيوسياسية الأمريكية الحالية.
ففي عام 1883، لفت قائد البحرية البريطانية نظر بلاده إلى صعوبة الالتزامات التي يتعيّن على البحرية البريطانية القيام بها، والتي تختلف طبيعتها اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، في ظلّ اثنين من أهم ضوابط التوسّع:
-
تجارة إمبراطورية كبيرة.
-
التزام بريطانيا بواجبات «بوليس البحار والمحيطات»، أي السيطرة والتفتيش والرصد والتربّص.
ويترتب على ذلك ضرورة الالتزام بالحفاظ على أسطولٍ مدرّعٍ قادر على مواجهة أي حالة طوارئ.
وختم هذا القائد البحري نصيحته بأن الخريطة أصبحت أوسع من القدرات المتاحة، إذ على بريطانيا أن تستخدم السفن المدرعة في كل من بحر الصين وبحر أستراليا، وفي المحيط الهادئ، وعلى ساحل أمريكا الشمالية، وفي جزر الهند الغربية. كما أكد هذا الأدميرال البحري أن الأسطول البريطاني مشتّت في هذه البحار بطريقة لا يمكن بها مواجهة أو قهر أسطول أي قوة أخرى منافسة.
ويبدو أن هذا الوضع البريطاني يشبه تمامًا وضع القوى البحرية الأمريكية حاليًّا في القرن الحادي والعشرين، حتى إنه في حال نشوب حرب عالمية ثالثة تمتد إلى ثلاثة أو أربعة بحار مختلفة، فقد تتمكن واحدة من القوى الأجنبية المنافسة من تركيز قواتها ضد الأسطول الأمريكي.
ويرى مؤلف الكتاب أنه لا فصل بين المشروع السياسي الداخلي ونظيره الخارجي، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في عديد من الدول في خريطة العالم المعاصر.
ويضرب المؤلف مثالًا بحالة الصين التي يمكن من خلالها فهم العلاقة المتبادلة بين السياسات الاجتماعية الداخلية للدول ورؤاها للجغرافيا السياسية الخارجية وصراعات الجيوبوليتيك.
لذا، فإن ما يقوم به الرئيس الصيني (شي جين بينغ Xi Jinping) من تعزيز النفوذ الشيوعي داخل المجتمع الصيني خلال السنوات العشر الماضية، يتسق ويعمل بشكلٍ متوازٍ مع مواقفه السياسية تجاه العالم الخارجي.
ويؤكد الكتاب على أن الجغرافيا، وإن كانت تبدو ثابتة، إلا أن أهميتها تتغيّر بمرور الزمن؛ فلا ثابت نهائي مع التطوّر في الأسلحة الحديثة. ويضرب لنا مثلًا بتقلّص مساحة الحماية النسبية التي وفرتها «المنطقة الوسطى» الروسية بين عامي 1941 و1945، فور تطوير قدرات الطائرات الأمريكية المسلحة نوويًّا.
وقد ترتب على هذا إعادة رسم خريطة القيود الإقليمية للحرب وبُعدها الزمني.
ويُعتبر الاقتصاد من العوامل المهمّة في تحولات الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقد نتج عن المزج بين كلٍّ منهما مصطلح «العوامل الجيواقتصادية» في التخطيط الاستراتيجي التفصيلي.
ومن الأفكار المهمة في هذا الكتاب مسألة «تعدد الحجج»، أي ظهور عديد من التفسيرات لنفس الحدث، مع جاهزية العديد من الحجج للدفاع عن تفسير دون غيره. ويترتب على ذلك أن نفس الظاهرة السياسية على خريطة الصراع العالمي تصبح عرضًا لتفسيرات متباينة، بل ومتداخلة، وأحيانًا متعارضة. في الوقت نفسه، عادةً ما يكون هناك تحالف مصالح وراء اتباع هذه الاستراتيجية دون غيرها، حتى لتبدو الاختلافات منسقة ومتوافقة.
ويرى البعض أن بوسعنا الرجوع إلى أمثلة جغرافية من الصراع على خط الزمن، حتى لتبدو هذه النماذج وكأنها أرشيف مفصّل، بمعنى أن الجغرافيا ليست وحدها قادرة على تفسير كل شيء، ويجب التعامل بحذر مع القائلين بأن الجغرافيا تمثل قوة بنيوية مستقلة.
في هذا السياق، يذكرنا المؤلف بتصريح فلاديمير بوتين، في خطابه عن حالة الأمة في عام 2005، واصفًا انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين». ومضى بوتين يقول: «لقد تركت هذه الكارثة ملايين الروس يعيشون في دول أجنبية». ويلاحظ المؤلف هنا أن حُجّة بوتين هي ذاتها الحجة التي استخدمها الانتقاميون الألمان في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
عصر الأنثروبوسين
يدعونا المؤلف إلى النظر بقدرٍ من التروّي والتمهل في القطع بتأثير الإنسان في التغير البيئي وقدراته الفائقة، لا سيما مع ظهور فكرة «عصر الأنثروبوسين»؛ أي عصر الإنسان الفائق القادر على التغيير الجذري في البيئة والحياة، وأثر النشاط البشري المُهيمن على كوكب الأرض. ونحن اليوم شهود عيان – كما شهدنا في الأمس – على الارتباط الوثيق بين الجغرافيا السياسية والزيادة السكانية. ففي الحربين العالميتين، توفرت لبعض الدول قوات بشرية ضخمة، وهو ما ساندها في القدرة على تحمل خسائر فادحة، كما فعل الاتحاد السوفيتي عام 1941، وألمانيا عام 1944، ثم مواصلة كلٍّ منهما القتال.
ويمكن القول إن هذه القوات التي كانت متوفرة للاتحاد السوفيتي وألمانيا هي أكبر بكثير مما هو متاح لكلتا الدولتين الآن، وهذا يؤثر على القدرة على مواصلة حرب الاستنزاف بين القوات التقليدية، وعلى قدرة هذه الدولة أو تلك لإدارة صراعات مكافحة التمرد.
لكن هل العالم اليوم يحتاج هذه القدرات البشرية والحشود الضخمة؟ يذهب الكتاب إلى مراجعة أثر التدخل الروسي المزعوم في الحملة الرئاسية لعام 2016 على بعض التصورات الجيوسياسية الأمريكية تجاه روسيا. علاوة على ذلك، في هذه الحالة وغيرها، يُصبح الوضع ديناميكيًّا بفضل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُسهم هذه الوسائل في العلاقات المعقدة بين الجغرافيا السياسية والتصورات الخاطئة والتصورات الصحيحة. المشكلة الأكثر صعوبة والتي تنتظرنا جميعًا في المستقبل، هي التوقعات بقدرة الذكاء الاصطناعي على صياغة هذه العلاقات والتأثير فيها.
طرق جديدة في البر والبحر
ينبه الكتاب الحالي إلى تغيرات جغرافية جديدة ستؤثر على الصراع في القرن الحادي والعشرين، في مقدمتها:
-
تسارع وتيرة إنشاء طرق برية جديدة، الأمر الذي يترتب عليه تغيرات جذرية جراء أنشطة الدول البرية الكبرى، ولا سيما مع البرنامج الصيني للسكك الحديدية.
-
يترتب على الاحتباس الحراري فتح طرق بحرية في القطب الشمالي. وقد قدم ذلك لروسيا إمكانيات عسكرية وسياسية واقتصادية جديدة جراء فتح هذه الطرق الجديدة في القطب الشمالي، مع منافسة صاعدة من الصين.
ويستدعي المؤلف من التاريخ لحظاتٍ فارقة. فقد ساعدت السكك الحديدية عمومًا على التوسّع الإقليمي والمصالح، حتى للقوى البحرية التي كانت محلّ تهديد. فقد خدم مصالح بريطانيا وفرنسا، التي سعتا إلى تطوير المستعمرات والنفوذ الخارجي من مواقع الموانئ، بنفس القدر الذي خدم به مصالح الدول القارية مثل روسيا.
بدءًا من عام 1879، أنشأت روسيا خط سكة حديد عبر الساحل الشرقي لبحر قزوين، إلى مرو عام 1886، وسمرقند عام 1888، وطشقند عام 1898، مع جسر دائم فوق نهر جيحون (آمو داريا) عام 1901. وقد اعتُبر هذا الخط بمثابة ترسيخ لموقف روسيا الراسخ في آسيا الوسطى، وأثار قلق البريطانيين بشدة من اقتراب روسيا من الهند.
وفي الشرق، ألزم الروس الصين بمنح امتياز لخط سكة حديد روسي إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي عبر منشوريا في الصين، والذي كان طريقًا أكثر مباشرة من الطريق المختصر على الأراضي الروسية. كان لروسيا الحق في نشر قوات لحماية السكك الحديدية، وهو تطبيق مهم لفكرة أن السكك الحديدية تُنشئ مصلحة يجب حمايتها بعد ذلك. وكجانب من جوانب الطبيعة الجيوسياسية ذاتية الدعم أو التراكمية، كانت هذه الحماية بدورها تعتمد على السكك الحديدية وقدرتها على نقل القوات.
وكانت أبرز النتائج المترتبة على طفرة السكك الحديدية هذه، توغل روسيا نحو الشرق، فبعد أن نجحت روسيا في الضم الإقليمي لأراضي نهر آمور في الفترة من 1858 إلى 1860، وتأسيس فلاديفوستوك عام 1860، حققت توسعًا كبيرًا في منشوريا.
السباق الألماني والسكك الحديدية
كان هناك أيضًا قلق بريطاني متزايد تجاه ألمانيا، التي كان لديها خطة جيوسياسية قائمة على السكك الحديدية، تضمّنت تطوير المستعمرات، لا سيما في أفريقيا، مثل الكاميرون، حيث كانت السكك الحديدية وسيلة لدعم التقدم في الداخل وما ينتج عنه من استغلال اقتصادي.
كان هناك أيضًا اهتمام باستخدام السكك الحديدية لتمكين ألمانيا من اختراق أي محاولة جغرافية لحصرها برًّا في أوروبا. استلزم هذا التوسع مدّ خطوط سكك حديدية من ألمانيا عبر حليفتها الرئيسية، النمسا، إلى البلقان، ومن ثم استخدام السكك الحديدية للاستفادة من الإمكانيات الجيوسياسية التي توفرها الإمبراطورية التركية المترامية الأطراف، والترويج الديني لمشروع سكك حديد الحجاز تحت شعار خدمة الحجاج إلى مكة والمدينة. كما ازداد هذا الاهتمام بعد فشل ألمانيا في التغلب على بريطانيا في السباق البحري، وهو فشل اتضح بحلول عام 1909.
بهذا المعنى، اكتسب نهج ماكيندر – الذي ركز على خطوط السكك الحديدية القارية – أهمية كبرى.
وقد استمر السعي إلى السكك الحديدية والتوسع البري والبحري من قوة عالمية إلى أخرى، حتى وصلنا إلى نموذج الصين التي تشهد تطويرًا سريعًا لأسطولها البحري، واهتمامًا متزايدًا بالمحيط الهادئ والمحيط الهندي والقطب الشمالي. ففي أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، سعت الصين إلى تعزيز نفوذها في جنوب غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر سليمان، وفانواتو Vanuatu، وتونغا Tonga، وبابوا غينيا الجديدة.
وخلال زيارته لفانواتو في يوليو 2023، حذر الرئيس الفرنسي ماكرون مما أسماه «الإمبريالية الصينية». كما أخبر كاليدونيا الجديدة أنه إذا انفصلت عن الحكم الفرنسي، فقد نجد فيها «قاعدة بحرية صينية غدًا».
خريطة الغد
عادت الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك إلى صدارة المشهد مع بداية القرن الحادي والعشرين، وبشكل خاص في أعقاب معاندة التوغل الغربي في أفغانستان والعراق بعد أحداث سبتمبر 2001. وقد تفاقم هذا التنافس في عام 2022 بالغزو الروسي لأوكرانيا، والتهديد الصيني لتايوان.
وبالانتقال إلى الفترة 2022–2024، أثارت أزمة أوكرانيا نقاشًا واسعًا حول مدى تفسير الموارد لمحاولة روسيا ضمّها، وبشكل أكثر تحديدًا: ما إذا كان هناك دافع رئيسي للسيطرة على جزء كبير من صادرات الحبوب العالمية، لا سيما مع النفوذ الدولي الذي قد يُحدثه ذلك.
تُنتج روسيا وأوكرانيا معًا 30٪ من تجارة القمح العالمية، وكميات كبيرة من الشعير والذرة. وقد أتاح هذا الأمر القدرة على استدامة التحدي والتأثير على المستوى الدولي، لا سيما في الدول الإفريقية المعتمدة على واردات الحبوب، مثل مصر. علاوة على ذلك، تُوفر صادرات الحبوب لأوكرانيا مصدر دخل وقيمة اقتصادية بالغة الأهمية لاستدامة اقتصادها، وتقليل حاجتها للدعم المالي الغربي.
وبموازاة ذلك، تجلّت أهمية ساحل البحر الأسود في أوكرانيا؛ فبينما تُنتج الحبوب على مساحة كبيرة، يتركز تخزين الحبوب ومعالجتها وشحنها في الموانئ. كما استخدمت روسيا القوة لفرض حصارها، لا سيما بنشر سفن حربية، وتلغيم المياه الساحلية، وشنّ هجمات بطائرات مسيّرة. وعلى صعيد تقليص القدرات الجيوسياسية ومواجهتها، شهد الصراع الأوكراني هجومًا على مراكز القيادة، ومرافق الاتصالات، ولا سيما الجسور، ومرافق الإمداد.
وقد برز دور الأقمار الصناعية في حرب أوكرانيا، حيث أُحبطت محاولات القرصنة الروسية بفضل مساعدة الأقمار الصناعية الأمريكية للجيش الأوكراني.
ولعب إيلون ماسك دورًا رئيسيًّا من خلال برنامج «ستارلينك» التابع لشركة «سبيس إكس». وبحلول منتصف عام 2023، كان لدى ماسك أكثر من 3500 قمر صناعي في المدار.
وفي المقابل، اختبرت روسيا أنظمة الحرب الإلكترونية الموجّهة ضد الأقمار الصناعية الأمريكية، لا سيما عن طريق التشويش عليها، ومن خلال الاستخدام المحتمل لصواريخ مضادة للأقمار الصناعية، قادرة على ضرب أهداف تدور بسرعة 17500 ميل في الساعة، والتي من شأنها، علاوة على ذلك، أن تُنتج حطامًا قادرًا على إتلاف أقمار صناعية أخرى، كما حدث في اختبار أُجري عام 2021، عندما تم تدمير القمر الصناعي السوفيتي المعطّل «كوزموس».
يُثير تطوير التكنولوجيا في هذه الحالة – المتمثّلة في الأقمار الصناعية والأسلحة المضادة لها – إشكاليات في التفكير في الجغرافيا السياسية، وتصويرها، وتقييم كيفية تأثير القدرات السيبرانية على الجغرافيا السياسية، لا سيما أنها تبدو قادرة على تجاوز المسافات. في الوقت نفسه، لا يمكن لهذه القدرات أن تُتيح احتلال الأراضي. علاوة على ذلك، فإن إمكانياتها الحركية محدودة للغاية.
ويختتم المؤلف معالجته لهذا الأمر بقوله:
إن الصراع بين روسيا والغرب اليوم يشبه أجواء القرن التاسع عشر أكثر مما يشبه القرن العشرين. ذلك لأن الصراع عاد اليوم للحديث عمّن يسيطر على قلب الأرض في شرق أوروبا، وهي نفس الفكرة التي كان يتحدث عنها ماكيندر قبل 120 سنة، في محاضرته عام 1904.
# جغرافيا # قراءات كتب # كتب # الصين # الولايات المتحدة الأمريكية # روسيا